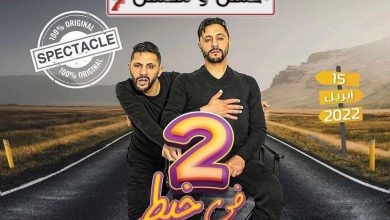للتمتع بهناء الرباط الزوجي لا بد للزوجين من تغذيته وتوفير اسباب استمراره وذلك من خلال الانفتاح المتبادل وتفهم كل من الزوجين لخصائص الآخر وحاجاته وأوجه قوته وضعفه وبنيته النفسية التي تفرض سلوكياته.لكن كل ذلك يشكل تحديات ليست هينة!!
سوء التوافق الزواجي والصراعات الأعمق والأكثر ديمومة تعود في الغالب الى قصور الزوجين في إدارة الحياة العاطفية، واقصد هنا التبادل الفعال بين الأفكار والانفعالات، ويظهر ذلك جليا في ممارسات قد نظن إنها عادية كتوجيه النقد القاسي الذي يستهدف الشخص وليس السلوك، والتهجم المحمل بالاحتقار أو الإشمئزاز حيث يسمح أحد الشريكان هنا لانفعالاته بتصدر الموقف مع تراجع تفهمه لانفعالات الآخر، مثل هذه المواقف تدل على إصدار حكم صامت على الآخر في موقف يصطبغ بصبغة انفعالية سلبية، دون أن ندرك إن الانفعال يحجب مميزات الآخر ويضخم سلبياته وأوجه قصوره.
تراكم الانفعالات السلبية كالغضب والإحباط أو القلق دون النظر في الذات والتواصل مع ما وراء الانفعالات، يؤدي الى التراكم الانفعالي والذي يقود إلى لحظة الانفجار والتي تسمى بنقطة “طفح الكيل” المعروفة في حالات الصراع والتي تتسم بتعطيل سيطرة العقل وضبطه، والتي تؤدي الى سلوكيات مؤذية وأحياناً مدمرة للعلاقة الزوجية.
يحدث كل ذلك نتيجة تجنب المكاشفة أو المجابهة الانفعالية، حيث تبقى القضايا تعتمل في النفس في حالة من القمع دون أي تعبير أو تنفيس مما يتسبب في التصعيد الانفعالي المتراكم، وفي ظل وجود ذلك الركام الانفعالي، تبرز كل الأفكار التحريفية وسوء تفسير سلوكيات الشريك والتي تتخذ طابع ” إنه يتعمد إزعاحي، أو استفزازي”، وحين تتعطل آلية محاكمة الأفكار التلقائية نكون بصدد انخفاض كبير في الذكاء العاطفي حيث نعجز عن التفهم أو التعاطف أو حتى مجرد التواصل مع الآخر.
بعد هذا التحليل نخلص الى أن الوعي بالمشاعر الذاتية والسيطرة عليها وحسن توجيهها من ناحية، وتحليل حالات الآخر واستيعاب انفعالاته الوجدانية من ناحية أخرى هو مايفتح الباب أمام تصفية القلوب وتهدئة النفوس وتصحيح الأفكار المنحرفة، وهي عملية تدخل في صلب الكفاءة العاطفية التي تمهد الطريق إلى التلاقي الفكري والوفاق الوجداني في علاقة الزواج.
من أهم ما أدعو إليه الأزواج أو المقبلين على الزواج هو الفهم العميق للاختلاف أن نتذكر دوماً أن عواطف الآخر وانفعالاته تختلف عن عواطفنا ومشاعرنا وانفعالاتنا بسبب الفروق البيولوجية والنفسية بين الجنسين،
فمثلاً غالب الزوجات يبحثن عن العلاقات الحميمية والحوار والتعبير والمشاركة في الوجدانيات، فهذا التركيز الوجداني من صلب مكونات الأنوثة التي زودت بها المرأة لتعينها للقيام بواجبات الأمومه ورعاية الطفل التي تحتاج لذلك المناخ الحميمي والدافئ الذي يؤسس لصحة الطفل النفسية وتفتحه على الحياة، بينما الطبيعة التطورية للرجل مختلفة تماماً وتذهب به في اتجاه الفعل.
هذا الاختلاف يؤسس لتكامل الأدوار في الأسرة ولكن عندما نعجز عن فهم الاختلاف وإدارته تبرز المشكلة فلما كانت عواطف الزوجة تحاول جاهدة شد الزوج إلى الحياة الداخلية تسعى عواطف الرجل للتملص من هذه الحياة الداخلية ويخاف أن تحاصره، لذلك فإن فهم عواطفنا وميولنا الفطرية والوعي بعواطف الآخر هو اهم الطرق لتعزيز الرباط الأسري والوصول للرضا الزواجي.
ولا يقتصر الاختلاف على الفرق البيولوجي والنفسي فقط وإنما يمتد الى فروق في الموروث النفسي الناتج عن التنشئة والتاريخ الشخصي لكل من الزوجين، فلابد من ادراك نظرة الشريك لذاته ومفهومه حول نفسه ومحاولة التوافق معه، وينسحب الأمر ذاته على تفهم توقعات الشريك وتوجهاته الحياتية ومشروعه الوجودي، بحيث يكون كل من الزوجين عوناً للآخر في إنجاز مشروعه. فكما نردد دائماً الحياة الزوحية تحتاج إلى تكوين وحدة في الرؤية وشراكة في الهدف وتضافر الجهود في المساعي.
وختاماً فإن السيطرة والاستبداد وغياب الأخذ والعطاء هو أكثر ما يعيق حياة الأسرة ويعطل وظائفها، بينما التعاون والتفاهم بحيث يجد كل فرد مكانه ويستطيع التعبير عن ذاته بحريه هو مايعظم إمكانات المجموعة ويعبئ طاقتها ويطلق مواهبها.